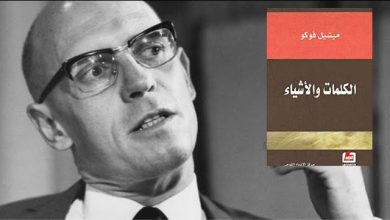أبحاث ودراسات
النموذج المثالي للتربية عند برتراند راسل – د.محمد عبدالنور

نسعى في هذا العرض المفصّل لفصل “غاية التربية” الوارد في كتاب برتراند راسل “عن التربية” الواقع بين الصفحة (83) والصفحة (61) والصادر عن دار منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت بترجمة سمير عَبدَة، والصادر لأول مرة بلغته الأصلية سنة 1926بلندن، وذلك لما وجدنا في آرائه من وجاهة قد تعين مجالنا التربوي على استصدار “عهد تربوي جديد” ولما يُتيحه من استيعاب شمولي لتاريخ التربية في كلياتها الرئيسية المتعلقة بالأهداف الكبرى، أو الخطوط العامة التي عليها يتم العمل على إعداد أجيال تتناسب عقليا ونفسيا مع طبيعة المرحلة الحضارية للأمم، وذلك انطلاقا من رؤية تحقيقية متّصلة تقف على النماذج السابقة وذروة تطورها وفقا لما بلغته التجارب التربوية كونيا، وفيما يلي جدول مواد هذا العرض:
-
سؤال التربية، السؤال لماذا نربي؟ قبل السؤال، كيف نربي؟
-
مقارنة التربية: بين الصينيين واليونان.
-
النموذج الياباني في التربية: التضحية بالكثير من أجل شيء واحد.
-
نموذج التربية في انكلترا: تكوين أرستقراطية الموظفين فلسفةً للتربية.
-
الإدماج التربوي في أمريكا: حرية نفسية مقابل تدجين عقلي وحسي.
-
مكانة الأبناء في الفعل التربوي: وسيلة أم غاية؟
-
الحيوية، الشجاعة، الإحساس، الذكاء: خطة راسُل لتربية مثالية.
-
في أن الحيوية أمان من الحسد المفسد.
-
كيف يمكن تحقيق شجاعة لا تقوم على ظلم الآخرين؟
-
الإحساس الفكري سبيلا وحيدة لإحقاق العدل والسلام في العالم.
-
الذكاء بين الرغبات الضيقة والصالح العام.
-
تربية النساء على الشجاعة والحب أصل التغيير الحقيقي.
-
على سبيل الختم.
1- سؤال التربية، السؤال لماذا نربي؟ قبل السؤال، كيف نربي؟
قبل البحث في كيفية تكوين شخص ما لابد قبل ذلك من التفكير في “نوع الشخص” المراد تنشئته، وتكوين رأي واضح عن الغاية من التربية، وذلك حتى نتمكن من تحقيق المبدأ الذي بدونه لا يمكن الوصول إلى تربية حقيقية، بقول آخر إن الأساس الذي عليه تبنى التربية الحقة هو الجواب عن السؤال لماذا نربي؟ قبل التفكير في الجواب عن السؤال كيف نربي؟
إن حُمق المربي يتجلى في عدم وصوله إلى النتائج التي كان يسعى إليها، وقدرة المربي تقاس تحقيقه للنتائج التي كان يرمي إليها في تربيته، وذلك دون النظر إلى صواب الهدف من عدمه، لكن المعيار هنا هو الفاعلية (بلغة بن نبي: صحة الفكرة لا تحدد فاعليتها، قد تكون الفكرة صحيحة لكنها غير فاعلة كما قد تكون الفكرة خاطئة وفاعلة).
2- مقارنة التربية: بين الصينيين واليونان.
كما كان يُجبر صبية أثينا على حفظ إلياذة هوميروس كاملة عن ظهر قلب، أُجبِر صبية الصين على حفظ مأثورات كونفوشيوس بنفس العناية والدقة، وكما كان الأثينيون يُعلّمون نوعا من الاحترام الظاهري للآلهة، بحيث لا يضع ذلك الاحترام حاجزا أمام التفكير الحر، كان الصينيون أيضا يتعلمون طقوسا تتعلق بتقديس الأجداد دون أن يجبروا على الاعتقاد بما كان منطويا في تلك الطقوس. لقد كان ينتظر من الإنسان الصيني المكوّن تربويا إظهار تشكك سهل ولبق في تلك الطقوس، فلا يقدّم أحكاما ونتائج قاطعة، بحيث تصلح الآراء أن تكون موضوعا للنقاش على مائدة الطعام، لا موضوع مخاصمة بين الرجال.
وعلى المنوال ذاته كان أكبر فلاسفة اليونان أفلاطون، فقد وصف بأنه: (أثيني مهذب رفيع، يبدو في بيت العبادة كأنه في بيته)، تماما كما كان حكماء الصين. إذ وباستثناء غوتيه (الشاعر الألماني 1749-1832) لم يكن ذلك دأب حكماء الحضارة المسيحية؛ والمحصلة هي أن الصينيين واليونانيين يتشاركون “الرغبة في الاستمتاع بالحياة”، ومصدر الاستمتاع هنا هو الجمع بين احترام التقاليد والتشكك المهذب، ويعتبر راسل ذلك تعبيرا عن إحساس فائق بالجمال.
لكن بالمقابل اختلف الصينيون عن اليونانيين النشطين في كونهم كسالى، لكنه كسل جعل من انهيار الحضارة الصينية غير ممكن إلا من الخارج، بينما تسبب نشاط اليونانيين في تدمير حضارتهم بأيديهم بواسطة الفنون والعلوم والاقتتال الداخلي بما لم يسبقهم إليه أحد، وقد وجدوا في السياسة والوطنية مصرفا لطاقاتهم، فضلا عن العزل الذي كان يتعرض له السياسيون إلى الريف والتلال لكتابة القاصائد، لكن ليست وحدها التربية مصدرا لذلك الاختلاف، ذلك أن الكونفوشيوسية في اليابان لم تعرف ذلك المثقف الكسول الذي كان عليه في الصين إلا ما ندر.
لقد انتجت التربية الصينية الاستقرار والفنون بينما فشلت في إنتاج التقدم والعلم، وتلك هي النتيجة المتوقعة من تربية قائمة على الشك في الأسلاف والمعتقدات، أما التربية القائمة على الاعتقاد (عدم الشك) فهي لن تنتج استقرارا، بل ستؤول حضارةٌ قائمةٌ على الاعتقاد إلى مآلين لا ثالث لهما: إما التقدم وإما الدمار. والعلم ذاته لابد أن يتحول إلى معتقد إذا أراد تحقيق التقدّم، فهو بعد مهاجمته عقائد الدين يتحول هو ذاته إلى تأسيس عقائده.
نضيف هنا، بأنه لابد من المعتقد سواء أكان دينيا أم علميا، وذلك لحاجة الأمم إلى طاقة تحافظ بها على نفسها، في دنيا مليئة بالتنافس والصراعات، ولايفيد هنا غير الاعتقاد سبيلا للحفاظ على الإنية الحضارية بالطريقة الفاعلة، خاصة في ظل عصر قرّبت وسائل الاتصال فيه بين أجزائها فصار “قرية كونية” لا يفيد فيها غير الاعتقاد الحاسم.
والمعتقد العلمي يحصر العلم في طبقة دون الأخرى، تماما كما كان في الصين حيث كانت نسبة المتعلمين ضئيلة، أما الحضارة اليونانية فقد قامت على الاستعباد حيث لا يصل العلم إلى جميع الطبقات، لذلك كان ضروريا على الصينيين مراجعة ذلك الأساس التربوي كما لم يكن النموذج اليوناني ليصمد إلى أبعد من القرن الثامن عشر حيث كان لابد من تعميم العلم.
3- النموذج الياباني في التربية: التضحية بالكثير من أجل شيء واحد.
التربية اليابانية مثال نموذجي للنزعة المسيطرة على أغلب الدول الكبرى، والتي تجعل من “عظمة الوطن” أسمى هدف للتربية، حيث الغاية تكمن في تخريج مواطنين مخلصين للدولة عن طريق ترويضهم عاطفيا حتى يهبوا كل معارفهم في خدمتها، وقد نجح اليابانيون نجاحا باهرا جعل من راسل يعترف بأنه لا يستطيع إيفاءهم الثناء الذي يستحقونه.
بوصول الأسطول الأمريكي (كومادور بري) إلى اليابان انكشف اليابانيون ووقعوا في ظرف أصبح من الصعب عليهم فيه حماية أنفسهم، الأمر الذي جعلهم ينهجون نمطا قاسيا جدا في التربية إلى درجة أنه يمكن اعتباره – أي النمط التربوي- جريمة لولا أن الخطر الداهم كان يفرض عليهم ذلك، ذلك أنهم واجهوا الغزو الحربي الأمريكي بفعل تربوي موجه لأبنائهم يحمل منطقا عسكريا في الصرامة.
أولا حرّموا الشك في مقدسات الشنتو، ديانة اليابانيين، حتى على الأساتذة الجامعيين، وبلغ تحكم رجال الدين عندهم مبلغا تجاوزوا به عصور الظلام في أوروبا، التحكم الذي انعكس على الأخلاق: الوطنية، احترام الآباء، عبادة المَلِك إلى درجة كاد ينعدم فيها كل تقدّم. فضلا عن أن الخطر الأعظم الذي يتهدد نظاما كهذا لم يكن إلا الثورة في سبيل تحقيق التقدّم.
هكذا كان عيب التربية في اليابان (نقيضا لنظيره الصيني القائم على الشك والكسل)، فقد كان المطلوب من الياباني ، حسب راسُل، الإسراف في العقائد والحماس لأجلها، فأسلوب التربية كان يرمي إلى غرس عقيدة “تحصيل المعرفة” ولو كانت صعبة، وحتى لو شاب تلك المعرفة شيء من الخطأ وعدم اليقين فإنه يمكن إصلاحها بشيء من الجهد، فضلا أن الحذر مطلوب جدا في المواطن التي يكون فيها الخطأ العلمي البسيط يجر إلى كارثة؛ لكن ورغم كل هذه النسبية التي تحوم بالمعرفة فقد كان لابد من أن تكون أساسا للمعتقد عند الإنسان الياباني، فهي تجعل العقل في حالة مستمرة من القلق والتوتر لما تتطلبه من “درجة عالية من الثقافة الفكرية”، ورغم كل ذلك يحكم راسُل بأن تحقيقها ليس مستحيلا لكونها في النهاية تعبير عن “المزاج العلمي”.
وعلى منوال الخطأ الياباني جاءت التربية اليسوعية (نسبة إلى جمعية يسوع التي أسسها الإسباني أغناتيوس ليولا) التي جعلت التربية في خدمة المؤسسة، وهي في المثال اليسوعي المؤسسة الكنسية الكاثوليكية، حينها لا يكون هدف التربية هو صالح التلاميذ لكن صالح المؤسسة، وبصرف النظر عن النظرة الدينية التي تزعم إنقاذ الأرواح من عذاب جهنم فإن الشاهد في المسألة هو مدى تحقيق اليسوعيين للنتائج التي كانوا يسعون إليها، (ومن رغم أن فولتير من خريجي التربية اليسوعية، إلا أنه انقلب عليها وأدار حربا فكرية على اليسوعيين)، ويحكم راسل بأن نتائج التربية اليسوعية لا تتحقق إلا في الآماد البعيدة.
المحصلة هي اضطرار النموذجين الياباني واليسوعي إلى التضحية بالكثير من الملكات من أجل تكوين الفرد الذي يسعون إلى تحقيقه، فكان من النتائج غير المرغوبة القضاء على الخيال المبدع في المجال الفني، تسطيح الفكر، انحلال الأخلاق (وهذا ما قد يبدو مناقضا للتوجهات الدينية لليسوعيين خاصة، لكن التعامل الفج مع الناشئة قد يؤدي إلى انحلالهم أخلاقيا رغم أن التربية تربية دينية بالأساس)، هكذا ومن أجل التخلص من شرور اليسوعيين في فرنسا كان لابد من الثورة، فقد كان خطؤهم الأكبر في التربية هو أن أهدافهم التربوية البعيدة أفقدتهم عاطفة الحب في التربية.
4- نموذج التربية في انكلترا: تكوين أرستقراطية الموظفين فلسفةً للتربية.
رغم المعارضة القوية لرجال الدين على انتخابه مفتشا للمعارف، إلا أن الدكتور ماثيو أرنولد (1822-1888) (هو الإبن البكر لتوماس أرنولد المستشرق صاحب كتاب “الدعوة إلى الإسلام” الذي عمل في جامعتي عليكرة ولاهور بالهند حيث كان أستاذا لفيلسوف الإسلام الحديث محمد إقبال) الذي استطاع أن يؤسس لسياسة تربوية تركت آثارها بشكل جلي على الإنسان الانكليزي، يقرر راسل أن عيبها كان الأرستقراطية التي سعت لإعداد الرجال للوظائف السامية داخل انكلترا وعموم المستعمرات البريطانية. لقد اقتضى بقاء الارستقراطية ونفوذها في بريطانيا إلى فضائل كان لابد من غرسها في نفوس الناشئة هي كما يلي:
-
البدن الصحيح والنشاط الدؤوب.
-
رسوخ معتقدات معينة في النفس.
-
الاحتفاظ بمعايير استقامة عالية.
-
الوعي بأهمية الرسالة المنوطة به.