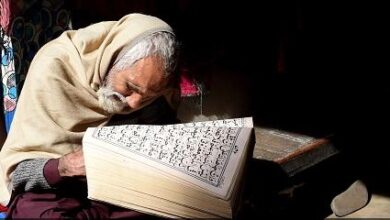التفكيكية من الفلسفة إلى النقد الأدبي – بقلم: ممدوح الشيخ

“التفكيكية” مصطلح ينتمي لعائلة من المصطلحات المتداولة في الدراسات النقدية المعاصرة، وهو مصطلح مثير للجدل بسبب ما يتضمنه معناه – كما سيرد – من مفاهيم معادية للغيبيات (الميتافيزيقا). وقد تمحور الاهتمام في التفكير النقدي العربي حول هذا المصطلح أمثاله بعد أن توقفت جهود كانت تستهدف إبداع نظرية نقدية عربية.
وكما هو الحال في معظم مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية مثلت قضية السياق الذي تنشأ فيه الأفكار وتنمو وتتطور قضية خلافية بين من يرون الظاهرة الإنسانية تتطور وفق قوانين ثابتة لا تتأثر بالسياق الحضاري الذي تنشأ فيه، ومن يرون كل فعل وفكرة انعكاسا لرؤية حضارية تتضمن بالضرورة – بشكل ظاهر أو مضمر – تصورات عن الذات والآخر والكون وما وراء الكون. وعلى كل حال فإن واقع الدراسات النقدية العربية مشغول بمدارس النقد ذات المنشأ الغربي من ظاهرية وبنيوية وتفكيكية و. . . . .
وسواء كان دافع الانشغال الخوف من تبعية ثقافية تطرق الأبواب مترافقة مع تبعية اقتصادية وسياسية وإعلامية تعطي مشروعية لهذه المخاوف أو كان دافعه الرغبة في اللحاق بقطار يتحرك بالفعل وفي رحلته محطات عديدة، فإن من المفيد إدارة نوع من الحوار الإيجابي حول هذه الأفكار والمدارس النقدية.
التفكيك / التقويض
أول مظاهر الجدل هو ما دار حول المقابل العربي للفظ الإنجليزي “ DECONSTRUCTION ” ، فبينما يرى الدكتور محمد عناني أن استخدام مصطلح التفكيكية هو استخدام موفق، فالتفكيك الذي اشتق منه المصدر الصناعي هو فك الارتباط أو حتى تفكيك الارتباطات المفترضة بين اللغة وكل ما يقع خارجها(1) يذهب مؤلفا “دليل الناقد الأدبي” إلى أن مثل هذه الترجمة لا تقترب من مفهوم صاحب النظرية، وإن كانا يقران أن مصطلح “التقويضية” الذي يستخدمانه يعيبه هو الآخر العيب نفسه، ولكنهما يفضلانه، فهي (أي النظرية) لا تقبل – حسب ما يذهب إليه نقاد عرب – البناء بعد التفكيك. فصاحب النظرية يرى أن الفكر الماورائي الغربي صرح أو معمار يجب تقويضه وتتنافى إعادة البناء مع المفهوم، فكل محاولة لإعادة البناء لا تختلف عن الفكر المراد هدمه، وهو الفكر الغائي(2).
ظهرت التفكيكية/ التقويضية على يد الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا في ثلاثة كتب أصدرها عام 1967(3)، وقد بدأ دريدا نظريته بنقد الفكر البنيوي الذي كان سائدا آنذاك بإنكاره قدرتنا على الوصول بالطرق التقليدية على حل مشكلة الإحالة، أي قدرة اللفظ على إحالتنا إلى شئ ما خارجه، فهو ينكر أن اللغة “منزل الوجود” ويعني بذلك القدرة على سد الفجوة ما بين الثقافة التي صنعها الإنسان والطبيعة التي صنعها الله. وما جهود فلاسفة الغرب جميعا الذين حاولوا إرساء مذاهب على بعض البدهيات أو الحقائق البدهية الموجودة خارج اللغة إلا محاولات بائسة كتب عليها الفشل. وقد وصف دريدا مواصلة هذا الطريق بأنها عبث لا طائل من ورائه وحنين إلى ماض من اليقين الزائف(4) عبر عنه الفكر الغربي بألفاظ لا حصر لها عن فكرة المبادئ المركزية مثل: الوجود، الماهية، الجوهر، الحقيقة، الشكل، المحتوى، الغاية، الوعي، الإنسان، الإله(5).
ورغم هذه الخصائص التي تتصف بها النظرية فإن دريدا يصر على عدم ارتباط مشروعه بالعدمية بل يرى أن قراءته التفكيكية/ التقويضية قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص دراسة تقليدية أولا لإثبات معانيه الصريحة ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من معان في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يصرح به، أي أنها تهدف إلى إيجاد شرخ بين ما يصرح به النص وما يخفيه. وبهذا تقلب القراءة التفكيكية/ التقويضية كل ما كان سائدا في الفلسفة الماورائية. ويرى دريدا أن الفكر الغربي قائم على ثنائية ضدية عدائية يتأسس عليها ولا يوجد إلا بها مثل: العقل/ العاطفة، الجسد/ الروح، الذات/ الآخر، المشافهة/ الكتابة، الرجل/ المرأة(6).
التفكيكية / التقويضية كمنهج نقدي
في كل قراءاته يقوم دريدا بسك مصطلحات يشتقها مما هو قيد الدراسة ولا يتأتى فهم النظرية إلا من خلال متابعة هذه المصطلحات والكيفية التي تعمل بها داخل النص المدروس، وجميعها تستعصي على الوجود إلا نتيجة تفاعلها داخل نصها، وأهم هذه المصطلحات كما صاغها دريدا:
الانتشار أو التشتيت “ DIFFERENCE ”
الأثر “ TRAC ”
الاختلاف/ الإرجاء “DEFFERANCE”
ويطلق جاك دريدا على مثل هذه المصطلحات التي يشتقها من المادة قيد الدراسة “البنية التحتية”(7).
الأثر “ TRAC ” :
صب دريدا جام غضبه على ما زعم البنيويون أنه طموح إلى اتباع المنهج العلمي، فالعلم في نظره – مثله في ذلك مثل الدين والفلسفة الميتافيزيقية – يقيم نظامه على ما يسميه “الحضور” ومعناه التسليم بوجود نظام خارج اللغة يبرر الإحالة إلى الحقائق أو الحقيقة. وهو يبسط حجته على النحو التالي: “تحاول الفلسفة الغربية منذ أفلاطون تقديم أو افتراض وجود شيء يسمى الحقيقة أو الحقيقة السامية المتميزة” أو ما يسميه هو “المدلول المتعالي” أي المعنى الذي يتعالى على (أو يتجاوز) نطاق الحواس ونطاق مفردات الحياة المحددة. ويمكن في رأيه إدراك ذلك من خلال مجموعة من الكيانات الميتافيزيقية التي احتلت مركز الصدراة في كل المذاهب الفلسفية مثل: الصورة، المبدأ الأول، الأزل، الغاية، الهيولي، الرب، ويمكن اعتبار اللغة المرشح الأخير للانضمام لهذه القائمة(8).
فمفهوم “الأثر” في التفكيكية/ التقويضية مرتبط بمفهوم الحضور الذاتي ودريدا يرى في الأثر شيئا يمحو المفهوم الميتافيزيقي للأثر وللحضور(9). وهدف دريدا هو تفكيك الفلسفة وتفكيك تطلعاتها إلى إدراك الحضور عن طريق ما حاول إثباته من أن عمل اللغة نفسه يحول دون الوصول إلى تلك الغاية. وفي مقابل التركيز على المقابلة بين الدال والمدلول (اللفظ والمعنى) عند سوسير يرفض دريدا أسبقية المدلول على الدال، لأن تصور سوسير كان يعني وجود مفاهيم “حاضرة” خارج الألفاظ(10).
الاختلاف/ الإرجاء “ DEFFERANCE ” :
هذا المصطلح سبب مشكلة في الترجمة بسبب الالتباس الحتمي المرتبط به، فترجمه البعض (الاختلاف والإرجاء)(11) وترجمه آخرون (الاختـ(ت)ـلاف)(12)، أما الدكتور عبد الوهاب المسيري فترجم هذا الاصطلاح إلى “الاخترجلاف” وهي كلمة قام بنحتها من كلمتي “اختلاف” و”إرجاء” على غرار كلمة “ LADIFFERANCE ” التي نحتها دريدا من الكلمة الفرنسية “ DIFFER ” ومعناها أرجأ والكلمة “ DIFFERENCE ” بمعنى اختلاف وتحمل معنى الاختلاف (في المكان) والإرجاء (في الزمان). ويرى دريدا أن المعنى يتولد من خلال اختلاف دال عن آخر، فكل دال متميز عن الدوال الأخرى ومع ذلك فهناك ترابط واتصال بينهما، وكل دال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات مع الدوال الأخرى، لكن معنى كل دال لا يوجد بشكل كامل في أية لحظة (فهو دائما غائب رغم حضوره)، وهكذا فالاخترجلاف عكس الحضور والغياب بل يسبقهما(13).
الانتشار أو التشتيت “ DIFFERENCE ” :
هذا المصطلح وأصله الإنجليزي “ DISSEMINATION ” ، كانت ترجمته هو الآخر موضوع اختلاف بين النقاد العرب، فبينما اختار الرويلي والبازعي ترجمته ” الانتشار والتشتيت ” اختار المسيري ترجمته “تناثر المعنى”، والكلمة يستخدمها دريدا في مقام كلمة دلالة وهي من فعل “ DISSEMINAT ” بمعنى : يبث أو ينثر الحبوب، وللكلمة معان أهمها: أن معنى النص منتشر فيه ومبعثر فيه كبذور تنثر في كل الاتجاهات ومن ثم لا يمكن الإمساك به. ومن معانيه أيضا: تشتيت المعنى – لعب حر لا متناه لأكبر عدد ممكن من الدوال، تأخذ الكلمة معنى وكأن لها دلالة دون أن تكون لها دلالة أي أنها تحدث أثر الدلالة وحسب(14). ويأخذ مصطلح تناثر المعنى بعدا خاصا عند دريدا الذي يركز على فائض المعنى وتفسخه وهو سمة تصف استخدام اللغة عامة(15).
بين الفلسفة والأدب
لم يبرز تأثير فلسفة دريدا في النقد الأدبي إلا في كتابات نقاد جامعة ييل وبخاصة بول دي مان، ويصور دي مان العلاقة بين الأدب والفلسفة بقوله: “إن الأدب أصبح الموضوع الأساسي للفلسفة ونموذجا لنوع الحقائق (أو الحقيقة) التي تطمح الفلسفة لبلوغها” ويعني ذلك أن الأدب لا يزعم أنه يحيل القارئ إلى الواقع الحقيقي خارج اللغة فهو تعريف خيالي، وتاريخ الفلسفة حسب تصور دي مان كان رحلة طويلة في دنيا الإحالة أو الإحالية، وإلى المضمون بعيدا عن الوعي بذاته، أي بأن الفلسفة استمدت أصولها من مصادر بلاغية أو من علم البلاغة نفسه. ويستند دي مان هنا على قول دريدا بأن الأدب يمكن اعتباره حركة تفكيك ذاتية للنص، إذ يقدم لنا معنى ثم يقوضه في آن واحد، فالأدب أقرب ما يكون إلى تجسيد مبدأ الاختلاف. وهو يحتفل بوظيفة الدلالة وفي الوقت نفسه بحرية عمل الكلمات في نطاق الطاقات الاستعارية وألوان المجاز والخيال دون الجمع بين المتناقضات فلا يصل أبدا إلى الوحدة(16).
وأهم ما يلاحظ هنا هو أن هذا التصور للأدب باعتباره نصوصا متداخلة ينفتح بعضها على بعض ولا يجد النص منها حدودا تمنعه من تجاوز ذاته بدلا من التصور القائم على وجود نص مستقل أو كتاب مغلق يناقض تعريف الأدب الذي جاء به النقد الجديد باعتباره عملا يتمتع بالوحدة العضوية. وتستند النظرية كذلك إلى ما يطلق عليه “خبرة القارئ” أو تجربة قراءته للنص وهو مرتكز يؤدي آخر الأمر إلى التصالح بين المعاني وتوحيد القوى المتصارعة وإحالة النص والقارئ جميعا في آخر المطاف إلى العالم الخارجي، ومن ثم يقول التفكيكيون – والكلام لجيفري هارتمان- إن الحقيقة الشعرية كانت تستمد حياتها في نظر النقد الجديد من العالم الخارجي باعتباره حقيقة فوق الواقع اللغوي أي متعالية عليه(17).
ويرى التفكيكيون أن المزية الأولى للأدب ترجع إلى أنه خيال أو كذب، فالشعر يحتفل بحريته من الإحالة وهو واع بأن إبداعاته ذات أساس تخيلي، ولذا فإنه لا يعاني مثلما تعاني النصوص الأخرى من مشكلة الإحالة إلى خارج النص وهو ما يلخصه أحد شراح النظرية – فيرنون جراس – بقوله: “ترجع أهمية الأدب في ظل التفكيكية / التقويضية إلى طاقته على توسيع حدوده بهدم أطر الواقع المتعارف عليها، ومن ثم فهو يميط اللثام عن طبيعتها التاريخية العابرة، فالنصوص الأدبية العظيمة دائما تفكك معانيها الظاهرة سواء كان مؤلفوها على وعي بذلك أم لا من خلال ما تقدمه مما يستعصي على الحسم. والأدب أقدر فنون القول على الكشف عن العملية اللغوية التي تمكن الإنسان بها من إدراك عالمه مؤقتا وهو إدراك لا يمكن أن يصبح نهائيا أبدا”(18).
لا شئ خارج النص :
تشكل هذه العبارة أساسا من أهم أسس النظرية التفكيكية/ التقويضية وقد عبر دريدا عن ذلك بقوله: “لا يوجد شئ خارج النص” ومعنى ذلك رفض التاريخ الأدبي التقليدي ودراسات تقسيم العصور ورصد المصادر لأنها تبحث في مؤثرات غير لغوية وتبعد بالناقد عن عمل الاختلافات اللغوية. ويعتبر التفكيكيون أن الغوص في الدلالات وتفاعلاتها واختلافاتها المتواصلة تعد معادلا للكتابة، فمن حق كل عصر أن يعيد تفسير الماضي ويقدم تفسيره الذي يرسم طريق المستقبل، فالتفسيرات أو القرارات الخاطئة المنحازة هي السبيل الوحيد لوضع أي تاريخ أدبي بالمعنى التفكيكي. وقد طبق جيفري هارتمان هذه القناعة على أعمال لودذوورث قتلت بحثا فانطلق بحدود تفسيراته لشعره وكتب مقالات مستوحاة من النص دون أن تتقيد به تحفل بالتوريات اللفظية بأشكالها المختلفة وإحالات الألفاظ والتعابير إلى أعمال سواه ومن ثم احتمالات التناص مظهرا في ذلك براعة يحسده عليها الشباب ولا يوافقه عليها الشيوخ لهدم المعاني التي ألفتها الأجيال على مدى قرنين من الزمان(19).
وحسب الدكتور محمد عناني فإن المذهب يشهد في التسعينات تحولا عجيبا يسمى “استخدام المصطلح دون مضمونه”، فالنقاد التفكيكيون أصبحوا يسخرون من القول بأن للغة وظيفة عقلانية أو معرفية وقد أجروا تعديلات غريبة على مفهوم العلاقة بين اللغة والواقع أو الحقيقة فبدأوا يرصدون حركة اللغة من الخارج عن طريق رصدها في تلافيف النص أو النص الباطن مثل الرغبات الجنسية (فرويد) أو المادية الماركسية أو ما وصفه نيتشة بالنزوع إلى التسلط وإرادة القوة. منهم من يقول إن هذه الرغبات غير العقلانية تساهم في عملية الدلالة على المعنى أكثر مما تساهم فيه المعرفة العقلية، وإن كان الدكتور عناني يصف هذه الاتجاهات الجديدة بأنها تنتفع بالتفكيكية/ التقويضية دون أن تكون تفكيكية/ تقويضية(20).
منتقدو التفكيكية/ التقويضية
من بين ردود الأفعال التي أثارتها النظرية انتقادات عديدة لعل أهمها في نظر ميجان الرويلي وسعد البازعي أنها رغم قدرتها التقويضية على زعزعة المسلمات التقليدية الميتافيزيقية الغربية تصل في النهاية إلى “عماية محيرة”، فدريدا لم يقدم بديلا عن مسلمات الميتافيزيقا الغربية بعد أن قوضها. بل إن البديل نفسه كما يرى دريدا نفسه سيتسم بسمات الميتافيزيقا لا محالة، لذا اكتفى دريدا بالتقويض. ويذهب الرويلي والبازعي ويشاركهما في ذلك عبد الوهاب المسيري إلى أن التفكيكية/ التقويضية تدين بمنهجها لممارسات التفسير التوراتي اليهودي وأساليبه. فكل ما فعله دريدا هو نقل الممارسات التأويلية للنصوص المقدسة اليهودية وتطبيقها على الخطاب الفلسفي مرسيا بذلك دعائم ما ورائية لاهوتية مألوفة لتحل محل الميتافيزيقا الغربية، أما المسيري فيرد الأفكار الرئيسة في نظرية دريدا إلى أصولها اليهودية، ففي مداخل: الأثر، تناثر المعنى، الهوة، الكتابة الكبرى والأصلية، التمركز حول المنطوق، من موسوعته يورد تأصيلا فكريا تاريخيا لهذا الأثر الواضح ليهودية دريدا وللفكر اليهودي في نظريته النقدية(21).
وقد نقل الدكتور عبد العزيز حمودة في “المرايا المحدبة” نماذج عديدة من النقد الذي وجه للتفكيكية/ التقويضية ي الغرب، فمثلا ليتش يقول في تمهيده لدراسته عن التفكيكية /التقويضية إنها باعتبارها صيغة لنظرية النص والتحليل تخرب كل شئ في التقاليد تقريبا وتشكك في الأفكار الموروثة عن العلاقة واللغة والنص والسياق والمؤلف والقارئ ودور التاريخ وعملية التفسير وأشكال الكتابة النقدية، وفي هذا المشروع فإن الواقع ينهار ليخرج شئ فظيع(22).
أما جون إليس وهو أحد أشهر منتقدي التفكيكية فيقول: “هناك وسيلة يلجأ إليها التفكيك/ التقويض للحفاظ على صلاحيته: تتم صياغة الموضوعات في مصطلح جديد وغريب وهو ما يجعل المواقف المألوفة تبدو غير مألوفة، ومن ثم تبدو الدراسات المتصلة غير متصلة. إن الهجوم على نظرية إحالة المعنى يترجم إلى هجوم على ميتافيزيقا الحضور برغم أن الاثنين يعبران عن الرأي الساذج القائل بالعلاقة بين الكلمات والأشياء، لكن المصطلحات تجعل الموضوع يبدو مختلفا”(23).
———————–
هوامش
(*) قدمت هذه الورقة في الورشة النـقدية التي نظمتها “دائرة الثقافة والإعلام” بحكومة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة – إبريل 2000 للفائزين بجوائز الدورة الثانية من “جائزة الشارقة للإبداع العربي”. وقد فاز كاتب الورقة بالمركز الثاني في مجال المسرح.
ونشرت في مجلة “الآطام” السعودية (إصدارة دورية تعنى بالإبداع والدراسات الأدبية تصدر عن نادي المدينة المنورة الأدبي) – العدد الثامن – شعبان 1421 – نوفمبر 2000 – الصفحات: 47 – 58.
(1) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 131.
(2) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 49 – 50.
(3) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة، سبق ذكره، ص 132.
(4) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة، سبق ذكره، ص 133.
(5) رامان سلون، ترجمة جابر عصفور (دكتور)، النظريات الأدبية المعاصرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، سلسلة آفاق الترجمة، سنة 1995، ص 163 – 164.
(6) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 50.
(7) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 54.
(8) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 135 – 136.
(9) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 55.
(10) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 137 – 138.
(11) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 138.
(12) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 60.
(13) عبد الوهاب المسيري (دكتور)، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية – نموذج تفسيري جديد، دار الشروق، مصر، الطبعة الأولى، 1999، المجلد الخامس، ص 426.
(14) عبد الوهاب المسيري (دكتور)، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية – نموذج تفسيري جديد، دار الشروق، مصر، الطبعة الأولى، 1999، المجلد الخامس، ص 437.
(15) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 66.
(16) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 143 – 144.
(17) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 145 – 146.
(18) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 147.
(19) محمد عناني (دكتور)، المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي/ عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص 148.
(20) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 54.
(21) ميجان الرويلي (دكتور) وسعد البازعي (دكتور)، دليل الناقد الأدبي، دون ناشر، 1415 هـ، ص 54 – عبد الوهاب المسيري (دكتور)، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية – نموذج تفسيري جديد، دار الشروق، مصر، الطبعة الأولى، 1999، المجلد الخامس، ص 420 إلى 440.
(22) عبد العزيز حمودة (دكتور)، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، رقم 232، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998، ص 291 – 292.
(23) عبد العزيز حمودة (دكتور)، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، رقم 232، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998، ص 296.